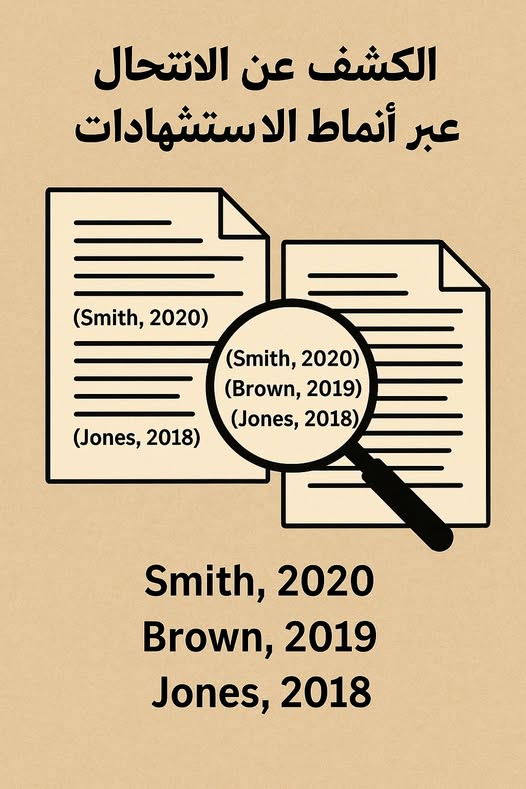في ميدان البحث التربوي والنفسي، كثيرًا ما يُقبل الباحث على تصميم أداة لقياس ظاهرة أو متغيّر معين. وهنا يواجه مفترقًا دقيقًا بين ثلاث أدوات متقاربة في الاستخدام، متباينة في الجوهر، وهي: الاستبيان، والاختبار، والمقياس. ورغم أن هذه الأدوات الثلاث تندرج جميعها تحت مظلة وسائل جمع البيانات، إلا أن فهم الفروق الدقيقة بينها يُعدّ مدخلًا لا غنى عنه لأي باحث جاد يتطلع إلى بناء أدوات علمية صادقة وثابتة.
الاستبيان هو أداة تُستخدم عادة للكشف عن المواقف أو الاتجاهات أو الخصائص العامة للأفراد، وذلك من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة إليهم، يجيبون عنها إما بصيغ مغلقة تُحدد لهم خيارات جاهزة، أو بصيغ مفتوحة تُتيح لهم التعبير الحر. ويمكن أن يشمل الاستبيان موضوعات تتعلق بالرأي، التفضيل، الاتجاهات، أو حتى بعض المعلومات الديموغرافية. غير أن طبيعة المعلومات التي يوفرها الاستبيان لا تُعدّ قياسًا مباشرًا للأداء أو للسلوك الفعلي، بل هي انعكاس لما يعتقده الفرد أو لما يحب أن يُظهره للآخرين. ومن هنا، فإن الاستبيان يتأثر بوعي المجيب، وخلفيته الاجتماعية، وربما أيضًا برغبته في تقديم صورة إيجابية عن نفسه، مما يجعل صدقه أحيانًا محل تساؤل إن لم تُصمم بنوده بعناية.
أما الاختبار، فهو أداة قياس تهدف إلى تقييم أداء الفرد في مهمة محددة، ويُعدّ من أقدم وأكثر الوسائل موضوعيةً ودقة، خصوصًا حين يُبنى وفق معايير علمية دقيقة. فالاختبار لا يسأل الفرد عن رأيه، بل يضعه في موقف محدد ويطلب منه أداءً فعليًا. هذا الأداء يُقوّم وفق مفاتيح تصحيح مسبقة، تتحدد فيها الإجابة الصحيحة والخاطئة، كما هو الحال في اختبارات التحصيل أو الذكاء أو القدرات. لذلك فإن الاختبار يقيس ما يستطيع الفرد أن يفعله أو ما يعرفه بالفعل، وليس ما يدّعيه أو يتخيله. وهذا يمنح الاختبار مكانة مرموقة في ميادين التعليم والتقويم النفسي والتربوي. كما أن دقته تعتمد بدرجة كبيرة على مدى صدقه وثباته، ومدى ملاءمته للفئة المستهدفة.
أما المقياس، فهو الأداة الأكثر تعقيدًا وتجريدًا، إذ يُستخدم لقياس سمات نفسية غير ملموسة مثل القلق، الاكتئاب، الاتجاهات، أو الرضا الوظيفي. هذه السمات لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، ولا يمكن تقييمها من خلال أداء واضح، بل تتطلب بناء أداة تتكون من عدد من البنود أو العبارات التي تمثل مظاهر مختلفة لتلك السمة. ويطلب من الفرد أن يعبّر عن مدى انطباق تلك العبارات عليه أو عن درجة موافقته عليها وفق تدريج معين، غالبًا ما يكون من نوع ليكرت. ومن خلال جمع درجات استجابته وتحليلها، يمكن استنتاج الدرجة التي تتوافر بها السمة لديه. ولأن المقاييس تتعامل مع مفاهيم نفسية مجردة، فهي تتطلب جهدًا مضاعفًا في بنائها، يشمل التحكيم العلمي، والتحليل الإحصائي، والتجريب الميداني، للتأكد من أنها تقيس فعلاً ما يُفترض بها أن تقيسه.
وإذا أردنا أن نضع خلاصة تأملية للفروق بين هذه الأدوات، أمكن القول إن الاستبيان يستطلع، والاختبار يُقيّم، والمقياس يكشف. فالاستبيان أقرب إلى الوصف، والاختبار أقرب إلى الحكم، والمقياس أقرب إلى التفسير. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يُستبدل أحدها بالآخر دون خلل في البناء المنهجي للبحث، فلكل أداة طبيعتها، ولكل هدف أداته المناسبة. ولعل من المهم هنا أن نذكّر بأن قوة البحث لا تكمن فقط في نتائج تحليله الإحصائي، بل في دقة الأداة التي انطلقت منها تلك النتائج.
إن الباحث الذي يُدرك هذه الفروق الجوهرية بين أدوات القياس لا يقع في فخ الخلط بين المواقف البحثية المختلفة، ويُحسن توظيف كل أداة في موضعها الصحيح. وبذلك، تتجسد الرصانة المنهجية التي كان يؤكد عليها أساتذنا الدكتور فؤاد أبو حطب، والتي تُعدّ من سمات الباحث المتمكن في ميادين التربية والنفس.
*الصورة لمعالى أ.د فؤاد أبوحطب الاستاذ بجامعة عين شمس ورئيس ومؤسس قسم التربية وعلم النفس بجامعة السلطان قابوس 1985-1990 رحمه الله تعالى رحمة واسعة
مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي